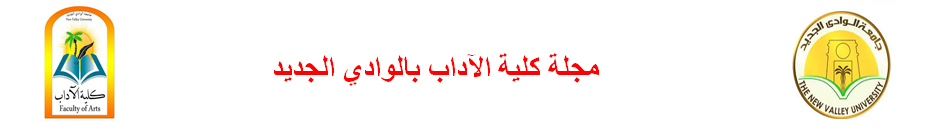
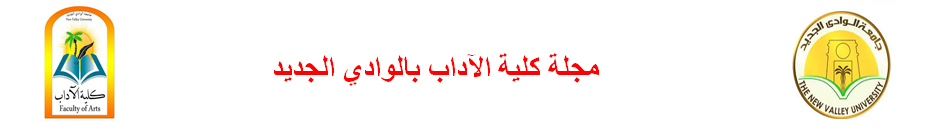
نوع المستند : بحوث علمية محکمة
المؤلف
جامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية
المستخلص
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقي البحث الصرفي والدلالي اهتماماً ورعاية منذ بداية الدرس اللغوي عند العرب بسبب أهميتها في معرفة فصيح الألفاظ ودلالتها وضبط أقيستها، ولا شک أنّ التکامل بين علوم اللغة وعلم الدلالة قائم لا يمکن الاستغناء عن أيّ واحد منها.
ونجد أنّ علماء اللغة قد ضبطوا صياغة الأبنية بعدة شروط يجب توفرها فيها في کل باب منْ أبواب التصريف؛ لکن هذه الشروط وقع فيها خلاف کبير بين النحاة؛ معتمدين على ما وصلوا إليه من الشواهد الفصيحة التي تؤيد آراءهم.
والحديث النبوي الشريف معينٌ وافر، ومورد زاخر لهذا الشواهد، وفصاحة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تضاهيها فصاحة، وأسلوبه لا يقاربه أسلوب ولکنّ علماء اللغة قل استشهادهم بشواهد الحديث النبوي الشريف؛ بسبب موقفهم من الحديث الشريف فقد جوز علماء الحديث الرواية بالمعنى، وظلت مسألة الاحتجاج بالحديث الشريف محط خلاف بين النحاة حتى وقتنا الحاضر.
من هنا کان هدف هذا البحث تسليط الضوء على نموذج من الأحاديث التي في ظاهرها مخالفة بعض القواعد التصريفية، فيدرسها من الجانب الصرفي والدلالي؛ لتساعد هذه الشواهد في ضبط القواعد الصرفية، وترجيح بعض الآراء المختلفة فيها، واختار هذا البحث ميدان الدراسة أن تکون في مسند الإمام أحمد الذي يعد أوسع المسانيد الحديثية في عدد الأحاديث الشريفة التي احتواها، ولذلک سمي بـ(المسند)، فإذا أطلق اسم المسند فالمقصود به مسند الإمام أحمد.
ويجيب البحث على الأسئلة التالية: هل وجد في مسند أحمد أحاديث خالفت القواعد الصرفية؟، وهل کان لهذه المخالفة أثرها الدلالي؟، وهل تماشى هذا المعنى الدلالي مع توجيه علماء اللغة الذي وجهوا هذا الأحاديث المخالفة للقواعد الصرفية؟
وقد استندت هذا البحث إلى منهج وصفي في البحث والتحليل، اتجه فيه إلى ملاحظة الظاهرة في صورها المختلفة، ثم رصدها وتعريفها محاولاً تقديم تفسيرٍ مؤسسٍ على ضوء ملاحظـات القـدامى والمحدثين من علماء اللغة، وشراح الحديث.
وعند البحث عن دراسات سابقة في الموضوع وقفت على دراسة بعنوان: اسم التفضيل: بين القاعدة النحوية وشواهد الحديث النبوي دراسة صرفية دلالية، وهي دراسة تتعلق بالأحاديث المخالفة للقواعد الصرفية، ولکنها مقتصرة على باب واحد من أبواب الصرف هو اسم التفضيل، کما إنها لم تعنَ بالترکيز على کتاب معين من کتب الحديث الشريف.
وقد جاء هذا البحث بعد المقدمة من تمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.
التمهيد: عرفت فيه بمسند الإمام أحمد، وعرضت فيه بإيجاز لمواقف علماء اللغة من الاستشهاد بالحديث الشريف.
المبحث الأول: استعمال المصدر والماضي من (يدع).
المبحث الثاني: صياغة اسم التفضيل.
المبحث الثالث: مجيء الفعل على صيغة (تفاعل).
المبحث الرابع: التغيير في بنية الکلمة لأجل المشاکلة من الواحد.
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.
وأتبعت ذلک بالمصادر والمراجع.
تمهيد
التعريف بمسند الإمام أحمد
مسند أحمد المعروف بـ المسند، هو أحد أشهر کتب الحديث النبوي وأوسعها، حيث يعدّ من أمهات مصادر الحديث، وهو أشهر المسانيد، يحتوي حسب تقديرات المحدثين على ما يقارب 40 ألف حديث نبوي، منها حوالي 10 آلاف مکررة مُرتَّبة على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، حيث رتبه فجعل مرويات کل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد 904 صحابةٍ، وقسَّم الکتاب إلى ثمانية عشر مسندًا، أولها مسند العشرة المُبشرين بالجنة، وآخرها مُسند النساء، وفيه الکثير من الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في الصحيحين([1]).
وقد أثنى العلماء على مسند الإمام أحمد وبيّنوا مکانته وفضله قال أبو موسى المديني عنه ((هذا الکتاب أصلٌ کبير، ومرجعٌ وثيق لأصحاب الحديث، انتُقيَ من حديثٍ کثيرٍ ومسموعات وافرة، فجعله إماماً ومعتمداً، وعند التنازع ملجأً ومستندًا))([2]).
وقال الذهبي ((فإنّه مُحتوٍ على أکثر الحديث النبوي، وقلّ أنّ يثبت حديثٌ إلا وهو فيه، وقلّ أنْ تجد فيه خبراً ساقطًا)) ([3]).
وقال ابن حجر العسقلاني: ((إن أحمد انتقى مسنده، ولا يشکّ مُنصفٌ أنّ مسنده أنقى أحاديث، وأتقن رجالاً من غيره، وهذا يدلّ على أنّه انتخبه))([4]).
موقف علماء اللغة من الاحتجاج بالحديث الشريف
للنحويين ثلاثة مذاهب في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف:
المذهب الأول: يرى منع الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف مطلقاً، واشتهر من نحاة هذا المذهب ابن الضائع وأبو حيان([5]).
المذهب الثاني: يرى الاستشهاد بالحديث النبوي الذي ثبت فيه نقل الألفاظ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، کالأحاديث التي فيها ألفاظ تعبدية، أو التي توصف بأنها من جوامع کلمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التي فيها خطاب للقبائل بلغاتها.
ويمثل هذا المذهب من النحاة الشاطبي([6])، والسيوطي([7]).
وأخذ بهذا الرأي من المحدثين الشيخ محمد الخضر حسين([8]).
المذهب الثالث: يرى الاستشهاد بالحديث النبوي مطلقاً، وأکْثَرَ أصحابه من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، وعلى رأسهم السهيلي وابن خروف وابن مالک والرضي وابن هشام([9]).
وأيد هذا المذهب عدد من النحاة منهم: ناظر الجيش([10]) والدماميني([11]) والبغدادي([12]).
ويترجح لي هذا المذهب لأمور:
الأول: تشدد الرواة من الصحابة ومن بعدهم في رواية الحديث، فلا يروون إلا ما تيقنوا منه، وإذا شک أحدهم في لفظ ذکر ذلک في روايته؛ لأنه يعلمون خطورة النقل الخاطِئ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ کَذَبَ عليَّ مُتعمِّداً فَلْيَتبوَّأْ مَقعَدَهُ مِن النَّارِ))([13]).
الثاني: حرص رواة الحديث وعلمائه على اللغة والتمکن منها، فقد رُوِيَ عن شُعبةَ بنِ الحجَّاجِ -ت 160هـ وهو أَحَدُ علماءِ الحديثِ ونقَّادِهِ- قولُهُ: ((مَنْ طَلَبَ الحَديثَ، ولم يُبصَّرِ العربيَّةَ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ علَيهِ بُرنسٌ، ليسَ لهُ رأسٌ))([14]).
المبحث الأول: استعمال المصدر والماضي من (يدع)
يرى علماء اللغة أنّ الفعل المضارع (يدَعُ) لا يستعمل منه فعل ماضٍ؛ فلا يقال: (ودَعَ).
يقول سيبويه: ((وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء فإنّهم يقولون يَدَعُ ولا يقولون وَدَع، استغنوا عنها بتَرَکَ))، وهو قول وابن خالويه([15])، وابن جنيّ([16]).
وکذلک لم يستعمل من الفعل (ودَع) المصدر، فقد بين العلماء أن کل فعلٍ استغني عنه بفعل آخر فيستغنى بمصدر ذلک الفعل عن مصدره يقول الشاطبي: ((ما استُغْنِيَ عنه بغيره من الأفعال فذلک الغَيْر يقوم مصدرهُ مقامَ مصدر هذا المرفوض، فکأنَّه موجود، فـ (التَرْک) قائم مقام (الوَدْع) کما کان (تَرَکَ) قائماً مقام (وَدَعَ) ))([17]).
وعلل العلماء ترک الفعل الماضي من (يدَعُ) بأنّ الماضي إنما هو: (ودَعْتُه) واسم فاعله (وادِع)، ففي أوله (واو) وهو حرف مستثقل، واستعمل في موضع ذلک: (ترَکَ) و (تارِک)؛ لأنهما في ذلک المعنى بعينه وليس في أوله حرف مستثقل([18]).
ورغم هذا الإهمال لصيغة الماضي والمصدر من الفعل (يدَعُ) فقد ورد استعمال الفعل (ودعَ) ماضياً في عدد من الأحاديث النبوية في مسند الإمام أحمد، منها قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَرُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ، أَوْ تَرَکَهُ النَّاسُ، اتِّقَاءَ فُحْشِهِ»([19]).
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْکَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَايْتَدِعُوهَا سَالِمَةً»([20])، قال ابن الأثير: ((أي: اترکوها، ورفِّهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى رکوبها، وهو افتعل من وَدُع- بالضم- وداعة ودَعَةً، أي: سکن وتَرَفَّه، وايتدع فهو مُتَّدع، أي: صاحب دَعَةٍ، أو من ودَع، إذا تَرَک))([21]).
ومن الأحاديث التي جاء فيها المصدر من الفعل (يدَعُ) قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَلَيُکْتَبنَّ مِنَ الغَافِلِينَ»([22])
فقوله: (عن وَدْعِهم) بفتح الواو وسکون الدال: قال في النهاية: ((أي عن تَرْکهم إياها والتخلف عنها))([23]).
وقد أجاز عدد من العلماء استعمال الماضي من الفعل (يَدَعُ) معللين ذلک، بأن استعمال ما أهملت العرب جائز صواب، وهو الأصل([24])، وقد جاء منه قول أبي الأسود الدؤلي([25]):
|
لَيْتَ شِعْرِي عَنْ خليلي ما الذي |
|
غَاله في الودِّ حتى وَدَعَه |
وقوله تعالى في قراءة من قرأ بالتخفيف([26]): {مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلَى}([27]).
وقد انتصر شراح الحديث لورود الماضي والمصدر من الفعل (يدَعُ) في الأحاديث الشريفة بأن ذلک حجة للجواز، قال القاضي عياض: ((قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات، وکل ذلک جاء منبهاً على الأصل المرفوض، والمستعمل الفصيح))([28]).
قال القرطبي: ((وهذا کله يرد على من قال من النحويين: إن العرب قد أماتت ماضي هذا الفعل ومصدره، ولا يُتکلم به استغناء عن ذلک بترکه))([29])، وقال: ((ولا معنى لقول من قال من مُتعسِّفة النحاة: لا يجوز التلفظ بهذه الأصول المرفوضة، مع صحَّة هذه الروايات، وشهرة تلک الکلمات))([30]).
وقال التوربشتي: (ودْعِهم) أي: ترکهم، ثبت هذا المصدر عن قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وثبت عنه الماضي أيضاً ...، وقد زعم علماء العربية -لا سيما النحاة منهم- أنّ هذا ميت مصدره، والماضي منه، وإنما يقال: (ترکه)، ويزعمون أن العرب قد ترکت النطق بهما، وربما جاء في ضرورة الشعر: (ودَعَه) فلا عبرة بما قالوا، إذ قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الحجة القاضية على کل ذي لهجة وفصاحة))([31]).
وبهذا يتبن لنا صحة استعمال الماضي والمصدر من الفعل (يدَع) وهو الأصل وإن کان قليلاً في النصوص الفصيحة مما جعل النحاة ينکرونه، وورود الأحاديث دليل على صحة استعماله، ويمکننا حمل کلام النحاة في قوله (أماتوه) بأنهم لم يکثروا استعماله، وأنّ الأکثر والأغلب استعمال (ترَک) و(التَّرْک) بدل (وَدَع) و(والوَدْع).
إنّ استخدام الفعل (وَدَع) بدل (تَرَک) هو نوعٌ من الانزياح والعدول اللغوي باستعمال الکلمة الغريبة، أو النادرة، أو المهجورة، لغرض دلالي داعم للمعنى؛ فالحديثان الشريفان وردا في سياق النهي عن أمرين محرمين، وهما: الفحش في الکلام والمعاملة، وترک صلاة الجمعة، واستخدام الکلمة النادرة في مثل هذا الموضع يضفي على المعنى شيئاً من الرهبة والنفور من المتَحَدَّث عنه؛ لما يحدثه من الصدمة للمستمِع وحاجته لإعمال الفکر في فهم معناه، وهذا ما لا يحققه الفعل (تَرَک)، کما أنّ في الفعل (وَدَع) ما ليس في (تَرَک) من المعاني؛ من ذلک الإشارة إلى الدعة وقلة الحرکة فيمن يترک صلاة الجمعة، وهي منقصة في حقه، ومنها الإشارة إلى أنها وديعة في ذمة العبد أودعها الله عنده فضيعها، ومنها إشارة إلى التوديع وهو الترک دون عودة، وذلک من الفعل المشدّد من (وَدَع) وهو (وَدّع) وهو علامة على الزهد في أداع الصلاة، وفي کل ذلک تنفيرٌ يتوافق مع الغرض الدلالي للحديث.
المبحث الثاني: صياغة اسم التفضيل
يشترط علماء اللغة في اسم التفضيل عدة شروط منها: أنْ يصاغ من فعلٍ، وأنْ يکون هذا الفعل ثلاثياً، مجرداً، تاماً، مثبتاً، متصرفاً، قابلاً للکثرة، غير مبنيٍ للمفعول، ولا معبرٍ عن فاعله بـ(أفْعَل فعلاء)([32]) .
وقد خالف هذه الشروط عدد من الأحاديث النبوية في مسند الإمام أحمد، وسأعرض لما خالف هذه الشروط من الأحاديث النبوية.
فمن الشروط أنْ يصاغ اسم التفضيل من فعْلٍ:
وقد خالف هذا الشرط من الأحاديث قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ، وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ»([33])، فقوله: (بأفسد) أفعل تفضيل من الإفساد، فهو مصوغ من اسم وليس من فعل، وقد أول عدد من شراح الحديث ذلک بتقدير اسم تفضيل مناسب، والإتيان بمصدر الفعل غير المستوفي للشروط، فقدر الطيبي (أشَدّ) قال: ((وهو أفعل التفصيل أي بأشد إفساداً))([34])، وکذلک قدره السيوطي([35])، وغيرهما([36])، وقدره ابن الملک بـ(أکْثَر إفساداً)([37]).
وخالف أيضاً هذا الشرط قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْکُنَّ»([38])، فـ(أغْلَبَ) أفعل تفضيل مصوغ من الغلبة، وهي اسم، فقدر له الشراح کذلک اسم تفضيل من فعلٍ مستوفٍ للشروط، فقُدِّر بـ(أشَدُّ غَلبَةً)([39])، أو (أکْثَرُ غَلبَةً)([40]).
ومن الشروط: أنْ يکون الفعل الذي صيغ منه اسم التفضيل فعلاً ثلاثياً مجرداً، وقد خالف هذا الشرط من الأحاديث قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»([41])، فجاء فيها اسم التفضيل من الرباعي فـ(أَحْصَنُ) أفعل تفضيل مصوغ من (حَصَّن)، وقد قدّر له الشراح اسم تفضيل مناسب وجاؤوا بالمصدر من الفعل، فقدر بـ(أشد إحصاناً)([42])، وبعض العلماء جعل (أَحْصن) لغير التفضيل معللاً ذلک بأنّ اسم التفضيل لا يکون من رباعي، بل جعله بمعنى اسم الفاعل([43]).
ومن الأحاديث التي ورد فيها اسم التفضيل من غير الثلاثي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا»([44])، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْرَى الْفِرَى مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ»([45]) فـ(أَفْرَى) في الحديثين اسم تفضيل من الفعل الخماسي (افترى) وهو فعل ثلاثي مزيد.
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَتْقَاکُمْ لِلَّهِ»([46])، و«وَإِنِّي لَأَتْقَاکُمْ»([47])، فـ(أتْقَى) اسم تفضيل من الفعل الثلاثي المزيد (اتَّقَى).
ومن الشروط: أنْ يکون الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل غير مبنيِ للمفعول، وقد جاء من الأحاديث في مسند أحمد مخالفاً لهذا الشرط قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»([48])، قال الکرماني: (( (أحَبُّ) أفعل التفضيل بمعنى المفعول على خلاف القياس، وإن کان کثيراً؛ إذ القياس أن يکون بمعنى الفاعل))([49])، وقد ورد اسم التفضيل (أحَبُّ) کثيراً في غير هذا الحديث في مسند الإمام أحمد([50]).
ومما جاء من اسم التفضيل مصوغاً من المفعول في الحديث (أَبْغَضَ) في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَدَعَنَّ النَّاسُ فَخْرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَيَکُونَنَّ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْخَنَافِسِ»([51])، وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا: إِمَامٌ جَائِرٌ»([52])، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَکُونُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبْغَضَ إِلَيْهِمْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ»([53])، وفي غير ذلک من الأحاديث([54])، فـ(أَبْغَضَ) في الأحاديث مصوغة من المفعول، قال ابن الملک: (( (أبغض): أفعل التفضيل من المفعول على الشذوذ))([55])، وجاء في التنوير: (( (أبغض) اسم التفضيل من بغض الثلاثي وهو هنا مبني للمفعول أي أشد الخلق مبغوضيةً))([56])، وبمثله قال غيرهما من الشراح([57]).
ومن الأحاديث التي جاء فيها اسم التفضيل من المفعول قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي کُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ»([58])، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيْرُ ذَلِکَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْکُمْ»([59])، وتکرر اسم التفضيل (أَخْوف) في الحديث في المسند([60])، قال السيوطي: (( (أخوف) من أفعل التفضيل المصوغ من فعل المفعول کقولهم: (أشغل من ذات النِّحْيَيْن) و (أزهى من ديک) ))([61])، وقال القاري في مرقاة المفاتيح: ((أَخْوَفَ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ))([62])، وکذلک قال غيرهما من شراح الحديث([63]).
ومن شروط اسم التفضيل ألا يکون الفعل معبراً عن فاعله بـ(أفْعَل فعلاء)؛ فلا يکون الوصف منه على (أفْعَل) الذي مؤنثه (فَعْلاء)، فلا يکون اسم التفضيل دالاًّ على لون فلا يقال: أبيض من فلان؛ لأنّ الوصف أبيض مؤنثه بيضاء.
وقد جاءت بعض الأحاديث مخالفة لهذا الشرط فمن ذلک ما جاء في المسند في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يصف نهر الکوثر: «هُوَ نَهَرٌ أَعْطَانِيهِ اللهُ فِي الْجَنَّةِ، تُرَابُهُ الْمِسْکُ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ»([64])
وقد حکم النحويون على هذا بالشذوذ([65])، يقول ابن مالک: ((ومن المحکوم بشذوذه قولهم: هو أسود من حنک الغراب. وقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صفة الحوض: (أبْيَضُ من اللَّبن) وإنما کان هذان شاذين؛ لأنهما من باب أفعل فعلاء))([66]).
وتنوعت مواقف شراح الحديث بين مخطئٍ للنحاة في قوله بأنّ هذا لا يجوز، وبين مؤول للحديث، فمن الشراح الذين خطّأوا النحاة في عدم جواز مجيء اسم التفضيل مما مؤنثه على أفعل فعلاء القرطبي قال: ((قوله: (ماؤه أبيض من الورق) جاء (أَبْيَضُ) هاهنا في هذا الحديث على الأصل المرفوض ...، والمستعمل الفصيح کما جاء في الرواية الأخرى: أشد بياضًا من الثلج، ولا معنى لقول من قال من مُتعسِّفة النحاة: لا يجوز التلفظ بهذه الأصول المرفوضة، مع صحَّة هذه الروايات، وشهرة تلک الکلمات))([67]).
وکذلک النووي قال: ((وَالنَّحْوِيُّونَ يَقُولُونَ إِنَّ فِعْلَ التَّعَجُّبِ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ هُوَ أَفْعَلُ مِنْ کَذَا إِنَّمَا يَکُونُ فِيمَا کَانَ مَاضِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ فَإِنْ زَادَ لَمْ يُتَعَجَّبْ مِنْ فَاعِلِهِ وَإِنَّمَا يُتَعَجَّبُ مِنْ مَصْدَرِهِ فَلَا يُقَالُ مَا أَبْيَضَ زَيْدًا وَلَا زَيْدٌ أَبْيَضُ مِنْ عَمْرٍو وَإِنَّمَا يُقَالُ مَا أَشَدُّ بَيَاضِهِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ کَذَا وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ أَشْيَاءُ مِنْ هَذَا الَّذِي أَنْکَرُوهُ فَعَدُّوهُ شَاذًّا لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ وَهِيَ لُغَةٌ وَإِنْ کَانَتْ قَلِيلَةَ الِاسْتِعْمَالِ))([68]).
وکذلک جعل الطيبي الحديث حجة على النحاة في جواز ذلک: ((قوله: (ماؤه أبيض) النحويون يقولون: لا يبنى فعل التعجب، وأفعل التفضيل من الألوان والعيوب، بل يتوصل إليه بنحو: أشد وأبلغ، فلا يقال: ما أبيض زيداً، ولا زيدٌ أبيضُ من عمروٍ، وهذا الحديث يدل على صحة ذلک، وحجةٌ على من منعوه، وهي لغةٌ وإن کانت قليلة الاستعمال))([69]).
ومن الشراح الذين أولوا الحديث فقدروا فعلاً مناسباً وجاؤوا بالمصدر من اسم التفضيل المظهري قال: ((قوله: (أبيض من اللَّبن)؛ أي: أشدُّ بياضًا منه؛ لأن ما هو من العيوب والألوان لا يُبنى من لفظه صيغة أفعل التفضيل والتعجب))([70]).
بالنظر إلى هذه الأحاديث التي خالفت بعض شروط اسم التفضيل التي وضعها علماء اللغة يمکننا القول إنّ هذه الشروط غالبة وليست مضطردة، وقد اختلف اللغويون في أکثرها.
ففي اشتراطهم کون اسم التفضيل مصوغاً من فعل ثلاثي، نقل الأصبهاني عن المازني جواز صياغة اسم التفضيل من الفعل بدون اشتراط کونه ثلاثياً([71])، وجوّز سيبويه صياغته من الفعل الثلاثي المزيد بهمزة([72])، وقصره بعضهم بعد بيان کثرته في النصوص على السماع([73]).
وجوّز ابن مالک صياغة اسم التفضيل من المبنى للمفعول إذا أُمِنَ اللبس، وأنّ ذلک ليس مقصوراً على السماع([74]).
وذهب عدد من اللغويين إلى جواز مجيء اسم التفضيل من الفعل معبراً عن فاعله بـ(أفْعَل فعلاء)، فجَوّزوا مجيْء اسم التفضيل من الألوان، والعيوب([75]).
والذي يظهر مع مجيْء عدد من الأحاديث مخالفة لهذه الشروط أنّ هذه الشروط غالبة، وليست مضطردة فإذا أُمِن اللبس واحتاج السياق إلى صياغة اسم التفضيل مما خالف هذه الشروط فهو جائز، ولا يحتاج إلى تأويل اسم تفضيل مستوفٍ للشروط.
ولا يخفى المقصد الدلالي لهذه الظاهرة الصرفية؛ حيث يمکن إجماله في أمرين: الأول: الاختصار؛ إذ إنَّ التعبير بکلمةٍ واحدةٍ أسرع في إيصال المعنى من التعبير بکلمتين، والثاني: تکشّف المعنى؛ فاستخدام أفعل التفضيل مباشرة من الفعل المقصود يؤدي المعنى بشکل أعمق وأسرع لذهن السامع من إبداله بالمصدر مع فعلٍ مساعد.
المبحث الثالث: مجيء الفعل على صيغة (تفاعل) من الواحد
ترد صيغة تفاعل للمشارکة فلا يصح مجيء الفعل منه إلا من اثنين فأکثر، تقول: تسابق محمد وخالد، فلا يصح أن تقول: تسابق محمدٌ، هذا الأصل في معنى صيغة (تفاعل)، وقد اختلف النحويون في مجيء الفعل على صيغة (تفاعل) من الواحد نحو: (تعاهد)، و(تعامل)، على رأيين:
الأول: يرى أن الفعل على صيغة (تفاعل) لا يکون إلا بين اثنين، يقول الجرجاني: ((وتَفَاعَلَ لمُشَارَکَةِ أمْرَيْنِ فصاعداً في أصلهِ صريحاً))([76]) وهو قول ثعلب([77])، والجوهريّ([78])، ونسب إلى الکوفيين([79]).
الثاني: يرى أن الفعل على صيغة (تفاعل) يکون من الواحد وغيره، فيجوز أن يکون (تفاعل) بمعنى (فعل)، وهو رأي ابن السراج قال: ((وأَما "تَفَاعلتُ" فلا يکونُ إلا وأَنتَ تريدُ فِعْلَ اثنينِ فصاعدًا))([80]) ، ورأي ابن درستويه قال: ((تقول: فلانٌ يتعَهَّد ضيعته يعني بتشديد (الهاء) على مثال (يَتَفَعَّل) أي يجدد بها عهده ويتفقد مصلحتها، وأنه لا يجوز فيه (يَتَعَاهد) لأنه على (يتفاعل) وهو عند أصحابه فِعْلٌ لا يکون إلا بين اثنين ولا يکون متعدياً مثل قولهم: (تعاملا)، و(تقاتلا)، ومثل (تغافل) و(تماسک) وهذا غلطٌ؛ لأنه قد يکون تفاعل أيضاً من واحد؛ ويکون متعدياً))([81])، وبه قال الزمخشري([82])، وابن يعيش([83])، وابن الحاجب، وغيرهم([84]).
ومما يؤيد هذا الرأي الثاني من الأحاديث في مسند الإمام أحمد مما جاءت فيها صيغة (تفَاعَل) بمعنى (فَعَل) قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُلْتَ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، تَعَاظَمَ، وَقَالَ: بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ، وَإِذَا قُلْتَ: بِسْمِ اللهِ، تَصَاغَرَ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الذُّبَابِ»([85])، ففي الحديث جاء لفظ (تعَاظَم) بمعنى: (عظُم) في نفسه؛ بمعنى أنه اعتقد أنه عظيم في حجمه وجرمه، وهذا يبينه ما جاء في الرواية الأخرى: «فَإِنَّهُ يَتَعَاظَمُ إِذَا قُلْتَ ذَلِکَ، حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْجَبَلِ»([86])، وأنّ له من القوة ما يقدر بها على غلبة غيره؛ ولذلک رتب على ذلک قوله: بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ، و(تَصَاغَر) بمعنى (صَغُر) أي: يصير صغيراً، ويذهب منه ذلک التعاظم، الذي يريه نفسه کالجبل، فيرى نفسه بما يجعل الله في نفسه من الخوف والاحتقار حتى يرى نفسه کالذباب.
ويدل استخدام (تَعَاظَم) و(تَصَاغَر) في الحديث بدل (عَظُمَ) و(صَغُر) على المُبَالَغَة؛ لأنّ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى لأن في معنى المفاعلة ما يظهر أنها جارية بين اثنين، لأنه کما يقول الطيبي: ((فإن الفعل الواحد إذا جرى بين اثنين يکون مزاولته أشق من مزاولته وحده))([87]) ففيها أنّ الشيطان يرى نفسه عظيماً، ويزداد هذا التعاظم حتى يرى نفسه کالجبل في الضخامة والحجم بسبب إرجاع العبد القوة للشيطان حتى لم يکن له حيلة إلا سبُّه بقوله: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فإذا استعان العبد بالله، وذکر اسمه تعالى تبدل الحال وانعکس الأمر، فيصير الشيطان صغيراً بتصغير الله إياه، وضعيفاً جداً حتى يکون کالذباب، في حجمه وضعفه.
وجاء في الحديث الأخر قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ فَلَا يَقُولَنَّ: اللهُمَّ إِنْ شِئْتَ، وَلَکِنْ لِيُعْظِمْ رَغْبَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ»([88])، فجاء الفعل (يَتَعَاظَمُ) بصيغة التفاعل للمبالغة، کما يقول شراح الحديث([89])، فلا يظن أنّ شيئاً عظيمٌ على الله، وليطلب من الله کل ما يتمنى مهما عظُم وکبُر.
وجاء في الحديث أيضاً من قول أنس بن مالکٍ رضي الله عنه: «فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْنَا الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ»([90])، فقوله: (يَتَحَادَرُ) بمعنى (يَحْدُر) أي ينزل ويقطر([91])، ففي استخدام صيغة التفاعل من المبالغة بکثرة ما ينزل على لحيته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ليس في صيغة يفْعُل.
فبالنظر إلى الأحاديث التي ورد فيها الفعل بصيغة (تَفَاعَل) وهو بمعنى (فَعَل) نستطيع أن نقول: إن الفعل على زنة (تَفَاعَل) يأتي من الواحد کما يأتي من الاثنين؛ لأنه مؤيد بالسماع، ويفيد المبالغة في الفعل؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.
وهناک ملحظ دلالي آخر لاستعمال (تفاعل) مکان(فَعَل)، وهو الإشارة إلى أنَّ الفاعل متعدد؛ ففي الحديث (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ) تشير الصيغة (يتَعَاظَم) إلى أنه مهما کان هذا الشيء متعدداً، أو کبيراً، أو کثيراً فإنه يسيرٌ على الله تعالى، وفي الحديث الآخر إشارة إلى أنّ تعاظم الشيطان وتصاغره يحدث من أکثر من جهةٍ؛ الأولى من الشيطان ذاته، فهو يصغر ويعظم بفعل نفسه، والثانية بفعل القائل (تعس الشيطان) أو (بسم الله)، فکأن الفعل يحدث منهماً معاً، وفي ذلک تصويرٌ لهذا العِظَم أو الصِغَر.
المبحث الرابع: التغيير في بنية الکلمة لأجل المشاکلة
خالفت بعض الکلمات في الأحاديث النبوية في بنيتها الصيغةَ التصريفيةَ الواجبة؛ لغرض من الأغراض اللفظية.
ويرى علماء اللغة أنّ العرب قد تغير في بنية الکلمة التصريفية مراعاة لغرض لفظي مثل المزاوجة والمشاکلة اللفظية([92])، فالمشاکلة عندهم تعني: ((وجود مماثلة أو مطابقة بين الأصوات، أو الصيغ، أو التراکيب، مما ينتج عنه تغيير في الصوت، أو الصيغة، أو الترکيب؛ لمماثلة صيغة أخرى، أو ترکيب آخر))([93])، والغرض من المشاکلة هنا ((إيثار الخفة والسهولة اقتصاداً في الجهد العضلي، حيث تتماثل الأصوات، أو تتقارب؛ فيتحقق الانسجام الصوتي وتتيسر عملية النطق))([94])، وللمشاکلة تأثيرها في الفصاحة کما يقول ابن سنان الخفاجي([95])، وقد مثل اللغويون للمشاکلة في الکلمات بقولهم: (الغدايا والعشايا) إذا قرنوا بينهما؛ فجاؤوا بکلمة الغدايا لموازنة العشايا، فإن أفردوا الغدايا ردوها إلى أصلها، فقالوا الغدوات، يقول السيرافي: ((قالوا: الغدايا والعشايا، فقالوا: (الغدايا) من أجل: العشايا، والغداة وحدها لا تجمع غدايا))([96]).
وقال ابن خالويه: ((قالوا: يأتينا بالغدايا والعشايا، ولا تجمع غداة على غدايا، وإنما أزوج بها العشايا))([97])، وقالوا إنّ هذا کثير في کلام العرب([98])
ومما جاء فيه هذا التغيير في البنية الصرفية لأجل المشاکلة قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ترحيبه بوفد عبدالقيس: ««مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ -أَوْ قَالَ: الْقَوْمِ- غَيْرَ خَزَايَا، وَلا نَدَامَى»([99])، (ندامَى) کان قياسه (نادمين) جمع الواحد (نادم)، لأن (ندامى) إنما هو جمع (نَدْمان)، وهو النديم الذي يرافقک ويشاربک، ولأجل المزاوجة والمشاکلة مع (خزايا) استخدم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ندَامَى) بدل (نادِمِين) فهو جمع على غير القياس([100]).
وقد حرص شراح الأحاديث عند شرحهم لهذا الحديث على التأکيد على کثرة ورود مخالفة البنية التصريفية لأجل المشاکلة في کلام العرب، وأنها من فصيح الکلام، قال النووي: ((جَمْعُ نَادِمٍ اتِّبَاعًا لِلْخَزَايَا، وَکَانَ الْأَصْلُ نَادِمِينَ، فَأُتْبِعَ لِخَزَايَا تَحْسِينًا لِلْکَلَامِ، وَهَذَا الْإِتْبَاعُ کَثِيرٌ فِي کَلَامِ الْعَرَبِ وَهُوَ مِنْ فَصِيحِهِ))([101]).
وعند النظر إلى الحديث نجد التناغم في النطق بين خزايا وندامى فيکون فيه إمتاع الأذن بما تحققه من جمال لفظي، بخلاف ما لو قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نادمين) فلا يکون لها هذا الجرس في الأذن، وقد وصف في هذا الموضع کما يقول ابن عاشور بأنه من أحسن الاستعمال([102]).
ومن المشاکلة التي غُيَّرت فيها بنية الکلمة في الحديث ما جاء عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حِکَاية قَولِ المَلَک للکافر في قبره إذا سأله الملک عن محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيقول ما أدري، فيرُدّ عليه الملک: «فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ، وَلَا تَلَيْتَ، وَلَا اهْتَدَيْتَ»([103])، وفي الرواية الأخرى أنهما ملکان جاء فيها «فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ»([104])، (ولا تليت) أصله: ولا تلوت، من تَلَا يَتلُو إذا قَرأَ، فقُلبت الواو ياءً لمشاکلة (دَرَيْتَ)؛ يعني: لا تقدر أنْ تقرأ وتقول ما هو الحق والصواب في القبر.
وقد تباينت آراء شراح الحديث تجاه هذه الصيغة فنسبها بعضهم إلى الخطأ من المحدِّثين، جاء في شرح السنَّة للبغوي: (( (وَلا تَلَيْتَ)، قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: هَکَذَا يَقُولُ الْمُحَدِّثُونَ، وَهُوَ غَلَطٌ)([105])، وقال التوربشتي (( (لا دريت ولا تليت) هکذا يرويه المحدثون، والمحققون منهم على أنه غلط))([106]).
واختلفوا في تقدير الصواب فذکر البغوي نقلاً عن يونس بن حبيب البصري أنَّ الصواب فيها (ولا أتْلَيْتَ) أي: دعاءٌ عليه بأنْ لا تتلى إبِلُه بأنْ لا يکون لها أولادٌ يتلونها([107])، وردّ هذا التقدير ابن سرّاج معللاً ذلک بأنَّ الميّت لا مال له([108])، وقدرهم بعضهم بتقدير آخر (( قال ابن الأنباري: ويجوز أن يکون ائتليت أي: لا دريت ولا استطعت أن تدري، يقال: ما آلوه، أي: ما أستطيعه))([109])، ونسب هذا إلى الأصمعي، والفراء([110])، وابن قتيبة([111])، وغيرهم([112]).
وردّ کثيرٌ من العلماء تخطئة من خطّأ لفظة (تَلَيْت) بأنها وردت في الأحاديث الصحيحة، ونقل هذا عن القاضي عياض قال: ((وما صحت به الرواية أولى))([113])، وقال الزيداني:
(( (ولا تليت) أصله: ولا تلوت، من تَلَا يَتلُو: إذا قرأ، فقُلبت الواو ياءً للازدواج، ... وقد قيل في (ولا تليت): إنه تصحيف، وقيل: مکان هذا ألفاظ أُخَر، وأعرضنا عن ذکرها لأن في أکثر الروايات وفي جميع نسخ "المصابيح، فاختصرنا بهذا))([114]).
ووجّه الحديث بأنه جاء على المشاکلة اللفظية، ونقل ابن بطال توجيه الحديث على المشاکلة عن ثعلب، قال: ((وقوله: (لا دريت ولا تليت) الأصل فيه تلوت، فردوه إلى الياء ليزدوج الکلام، هذا قول ثعلب))([115])، وکذا جاء هذا التوجيه عن ابن السکيت([116])، ودافع ابن مالک عن الحديث بأنّ الخروج عن الأصل لقصد المشاکلة کثيرٌ، وأنّ له نظائر کثيرة([117])، وقال العيني عن توجيه الحديث على المشاکلة: ((هَذَا أصوَبُ من کل مَا ذَکرُوهُ فِي هَذَا الْبَاب)) ([118]).
والذي يظهر للباحث کما قال عددٌ من شراح الحديث أنه لم يکن هناک غلط من المحدّثين والرواةـ، وإنما أورد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديث على المزاوجة والمشاکلة اللفظية، وهو أسلوب کما يقول علماء اللغة شائعٌ في العربية، وله الوقع والجرس في الأذن، فالملاءمة التي تحصل من المزاوجة تجعل الکلام حسناً في السمع فيکون للمعنى مکانٌ في نفس السامع لحسن صورة الکلام الذي امتثل لها.
الخاتمة
بعد هذه المحاولة لتتبع الأحاديث ودراسة الظواهر الصرفية الدلالية في مسند الإمام أحمد والتي بينت موقف اللغويين وشراح الحديث من هذه الظواهر فإنني أشير إلى مجمل النتائج التي توصل إليها البحث فيما يلي:
ويوصي البحث بتوجيه الدراسات البحثية إلى الأحاديث النبوية في کتب الحديث في مصنفاتها المختلفة، وتخصيص دراسات للظواهر اللغوية والنحوية فيها، وربط الظاهرة اللغوية بالظاهرة الدلالية ففيها الأثر الکبير على القواعد العربية، من ناحية التأصيل، والتوضيح والتبيين.
والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
([1]) ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (أحمد بن عبدالرحمن بن محمد البنا الساعاتي ١٣٧٨ هـ، دار إحياء التراث العربي، ط2، ب ت) 10، الحديث والمحدثون (محمد محمد أبو زهو، دار الفکر العربي، ط2، القاهرة ١٣٧٨هـ) 369-370، منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر (علي عبدالباسط مزيد، الهيئة المصرية العامة للکتاب، ب ت) 394.
([2]) خصائص مسند الإمام أحمد (أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني ٥٨١هـ، مکتبة التوبة، ط1، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م) 13.
([3]) المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد (شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري 833هـ، مکتبة التوبة، الرياض 1410هـ - 1990م) 11.
([4]) النکت على کتاب ابن الصلاح (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ٨٥2هـ، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط1، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م) 1/73.
([5]) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب (أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي أبو حيان 745هـ، تحقيق: رجب عثمان، مراجعة: رمضان عبدالتواب، مکتبة الخانجي ـ القاهرة، ط 1، 1418هـ ـ 1998م) 2/791، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش ٧٧٨ هـ، تحقيق: علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام، القاهرة – مصر، ط1، ١٤٢٨ هـ) 9/4410، والاقتراح في أصول النحو (عبدالرحمن بن أبي بکر، جلال الدين السيوطي ٩١١هـ، ضبطه وعلق عليه: عبدالحکيم عطية، راجعه وقدم له: علاء الدين عطية، دار البيروتي، دمشق، ط2، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م) 43، وعقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (عبدالرحمن بن أبي بکر، جلال الدين السيوطي ٩١١هـ، تحقيق: سَلمان القضَاة، دَار الجيل، بَيروت – لبنان ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م) 1/68، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (عبدالقادر البغدادي، تحقيق: عبدالسلام هارون، مکتبة الخانجي ـ القاهرة، ط 1، 1406هـ ـ 1986م) 1/10، وإتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهاد (محمود شکري الألوسي 1342هـ، تحقيق: عدنان عبدالرحمن الدوري، مطبعة الإرشاد، بغداد 1402هـ -1982م) 80.
([6]) ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الکافية (أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي ٧٩٠ هـ، تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين وآخرون، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - مکة المکرمة، ط1، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م) 3/412، وخزانة الأدب1/12، وإتحاف الأمجاد 88.
([8]) ينظر: دراسات في العربية وتاريخها (محمد الخضر حسين، المکتب الإسلامي، مکتبة دار الفتح سوريا، دمشق، 1380 هـ 1960 م) 175.
([9]) فيض نشر الانشراح من روض طيّ الاقتراح (عبدالرحمن بن أبي بکر، جلال الدين السيوطي ٩١١هـ، تحقيق: محمود يوسف فجال، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث – الإمارات، 1423هـ – 2002م) 446- 447.
([11]) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد (محمد بدر الدين بن أبي بکر بن عمر الدماميني ٨٢٧ هـ، تحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن محمد المفدى، بدون ناشر، ط1، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م) 4/241.
([13]) صحيح مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ٢٦١ هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه، القاهرة، ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م) 1/10.
([14]) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: (عثمان بن عبدالرحمن بن الصلاح 643هـ، نشره محمد راغب الطباخ، المطبعة العلمية، حلب، 1993م) 165، ونُقِل مثلُ هذا الکلام عن حماد بن سلمة قال: ((مَثَلُ الَّذِي يَطلُبُ الحدِيثَ ولا يَعرِفُ النَّحوَ مَثَلُ الحِمارِ علَيهِ مِخلاةٌ لا شَعيرَ فيها)) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن 911هـ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، المکتبة العلمية، 1959م) 317.
([15]) إعراب القراءات السبع وعللها (ابن خالويه، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الطبعة الأولى، الخانجي، القاهرة، 1413هـ) 2/495.
([16]) الخصائص (أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 392ه، تحقيق: محمد علي النجار، الطبعة الثانية، دار الهدى، بيروت، ب ت) 1/99.
([17]) المقاصد الشافية 4/488، وينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والکوفيين (أبو البرکات کمال الدين عبدالرحمن بن محمد الأنصاري الأنباري ٥٧٧هـ، المکتبة العصرية، ط1، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م)2/396.
([18]) تصحيح الفصيح (أَبُو محمد، عبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُسْتَوَيْه ابن المرزبان ٣٤٧هـ، تحقيق: عبد الله جبوري، ط1، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1395هـ)260.
([19]) مسند الإمام أحمد بن حنبل (الإمام أحمد بن حنبل ٢٤١ هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبدالله بن عبدالمحسن الترکي، مؤسسة الرسالة، ط1، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م)40/127.
([21]) النهاية في غريب الحديث والأثر (مجد الدين أبو السعادات المبارک الشيباني الجزري ابن الأثير ٦٠٦هـ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، المکتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م). 5/166.
([25]) ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، دار ومکتبة الهلال، 1418هـ) 350، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 392ه، تحقيق: علي النجدي ناصف، وعبد الحليم النجار، وعبد الفتاح شلبي، الطبعة الثانية، دار سزکين، 1406هـ) 2/364 ، والخصائص1/99، إعراب القراءات الشواذ (أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العکبري، تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز، ط1، عالم الکتب، بيروت، 1417هـ) 2/721.
([26]) هي قراءة شاذة قرأ بها عروة بن الزبير ، وابنه هشام ، وأبو حيوة ، وابن أبي عبلة، ينظر: مختصر في شواذ القرآن (أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه ٣٧٠هـ، مکتبة المتنبي، القاهرة، ب ت) 175، والمحتسب2/364، وإعراب القراءات الشواذ للعکبري 2/721، وتفسير البحر المحيط (أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، ط1، دار الکتب العلمية، بيروت، 1413هـ) 8/480.
([28]) إِکمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم (أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، ٥٤٤هـ، تحقيق: يحْيَى إِسْمَاعِيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط1، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م) 7/264، وينظر: عقود الزبرجد 1/483.
([29]) المفهم لما أشکل من تلخيص کتاب مسلم (أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ٦٥٦هـ، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال، دار ابن کثير، دمشق – بيروت، دار الکلم الطيب، دمشق – بيروت، ط1، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م) 6/574.
([31]) الميسر في شرح مصابيح السنة (فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبدالله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي ٦٦١ هــ تحقيق: عبدالحميد هنداوي، مکتبة نزار مصطفى الباز، ط2، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م) 1/334-335.
([32]) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله ٥٣٨هـ، تحقيق: علي بو ملحم، مکتبة الهلال – بيروت، ط1، ١٩٩٣م) 232 ، وشرح التسهيل (جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالک 672هـ، تحقيق: عبدالرحمن السيد، محمد بدوي المختون، دار هجر ـ الرياض، ط1، 1410هـ ـ 1990م) 3/50 ، وشرح الکافية (محمد بن إبراهيم بن جماعة 733هـ، تحقيق : محمد عبدالنبي عبدالمجيد ، دار البيان ـ القاهرة، ط1 ، 1408هـ ـ 1987م) 347، وارتشاف الضرب 4/ 2077 ، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع (جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بکر السيوطي، تحقيق: عبدالعال سالم مکرم، دار البحوث العلمية، الکويت، 1395هـ - 1975م) 6/41.
([36]) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي ثم المناوي القاهري ١٠٣١هـ، مکتبة الإمام الشافعي – الرياض، ط3، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م) 2/349، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (أبو العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المبارکفورى ١٣٥٣هـ، دار الکتب العلمية – بيروت، ب ت) 7/39.
([37]) ينظر: شرح مصابيح السنة للإمام البغوي (محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّينِ عبداللطيف بنِ عبدالعزيز الرُّوميُّ الکَرمانيّ المشهور بـ ابن المَلَک ٨٥٤ هـ، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، إدارة الثقافة الإسلامية، ط1، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م) 5/396، ومرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح (نور الدين أبوالحسن علي بن محمد الملا الهروي القاري ١٠١٤هـ، دار الفکر، بيروت – لبنان، ط1، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م) 8/3243.
([40]) ينظر: الکوکب الوهَّاج والرَّوض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (محمد الأمين بن عبدالله الأُرَمي العَلَوي الهَرَري، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور: هاشم محمد علي مهدي، دار المنهاج - دار طوق النجاة، ط1، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م) 2/572 .
([41]) مسند أحمد 1/470-471، وفي الرواية الأخرى في المسند: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ» 6/72، 7/122، 7/132.
([42]) ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب (أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بکر بن إبراهيم العراقي ٨٠٦هـ، أکمله ابنه: ولي الدين، ابن العراقي ٨٢٦هـ، دار إحياء التراث العربي، ب ت) 7/6، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 852هـ، رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه: محب الدين الخطيب دار المعرفة ، بيروت، ١٣٧٩هـ) 9/109، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي، دار ابن الجوزي، ط1، ١٤٣٦هـ) 25/18.
([43]) ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى بکر بن عبدالملک القسطلاني القتيبي المصري ٩٢٣هـ، المطبعة الکبرى الأميرية، مصر، ط7، ١٣٢٣هـ) 8/7، وفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحکام (شيخ الإسلام أبو يحيى زکريا الأنصاري الشافعي الخزرجي ٩٢٥هـ، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبدالموجود، دار الکتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م) 510.
([49]) الکواکب الدراري في شرح صحيح البخاري (محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الکرماني ٧٨٦هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، ط2، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م) 1/97، وينظر: عقود الزبرجد 1/152.
([50]) ينظر: مسند أحمد 5/248، 5/447، 6/113، 6/129، 7/138، 9/323، 10/296، 13/487، 14/431، 19/61، 19/104، 19/104.
([56]) التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ (عز الدين أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني ١١٨٢هـ، تحقيق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، مکتبة دار السلام، الرياض، ط1، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م) 1/246.
([57]) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى العينى ٨٥٥هـ، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ب ت) 24/44، وشرح القسطلاني على البخاري 10/52التنوير شرح الجامع الصغير 1/246، مرعاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح (أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبدالسلام بن خان محمد الرحماني المبارکفوري ١٤١٤هـ، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية، نارس الهند، ط3، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م) 1/237.
([63]) ينظر: لمعات التنقيح في شرح مشکاة المصابيح (عبدالحق الدِّهلوي 1052هـ، تحقيق: تقي الدين الندوي، دار النوادر - دمشق، ط1، 1435هـ - 2014م) 8/159، وکفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه المعروفة بـ حاشية السندي على سنن ابن ماجه (نور الدين أبو الحسن محمد بن عبدالهادي التتوي السندي ١١٣٨هـ، دار الجيل - بيروت، ط2، ب ت) 2/508.
([68]) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (أبو زکريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ٦٧٦هـ، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط2، ١٣٩٢هـ) 15/55.
([69]) الکاشف عن حقائق السنن -شرح الطيبي على مشکاة المصابيح- (شرف الدين الحسين بن عبدالله الطيبي ٧٤٣ هـ، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، مکتبة نزار مصطفى الباز، مکة المکرمة – الرياض، ط1، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م) 11/3516.
([71]) ينظر: الدرة الفاخرة (لحمزة ببن الحسن الأصبهاني، تحقيق : عبدالمجيد قطامش، دار المعارف - القاهرة، 1392هـ) 1/59.
([72]) ينظر: الکتاب (عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه ١٨٠هـ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، مکتبة الخانجي، القاهرة، ط3، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م) 1/73.
([73]) ينظر: لمعات التنقيح (في شرح مشکاة المصابيح، لعبد الحق الدِّهلوي (1052هـ)، تحقيق : تقي الدين الندوي، دار النوادر - دمشق، ط1، 1435هـ - 2014م) 1/248.
([76]) ا المفتاح في الصرف (أبو بکر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الفارسي الجرجاني ٤٧١هـ، تحقيق: علي توفيق الحَمَد، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م) 50.
([77]) ينظر: الفصيح (أبوالعباس أحمد بن يحيى الشيباني المعروف بثعلب 291هـ، تحقيق: عاطف مدکور، دار المعارف، ب ت) 305، وتصحيح الفصيح 389، وشرح الفصيح (ابن هشام اللخميّ 577هـ، تحقيق: مهدي عبيد جاسم، ط1، 1409هـ) 185.
([78]) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثالثة، دار القلم للملايين، بيروت، 1404هـ) 2/6.
([79]) ينظر: تصحيح الفصيح 389، والاقتضاب في شرح أدب الکتَّاب (أبو محمد عبد الله بن محمد بن السِّيد البَطَلْيَوسي ٥٢١هـ، تحقيق: مصطفى السقا، وحامد عبد المجيد، دار الکتب المصرية، القاهرة 1996م) 2/182.
([80]) الأصول في النحو (أبو بکر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج ٣١٦هـ، تحقيق: عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان – بيروت، ب ت) 3/120.
([83]) ينظر: شرح المفصل (أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا الزمخشري ٦٤٣هـ، قدم له: إميل بديع يعقوب، دار الکتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م) 4/438.
([84]) ينظر: الشافية في علم التصريف (أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الکردي ٦٤٦هـ، تحقيق: حسن أحمد العثمان، المکتبة المکية – مکة، ط1، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م) 1/20، والکناش في فني النحو والصرف (أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ٧٣٢ هـ، تحقيق: رياض بن حسن الخوام، المکتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، ٢٠٠٠ م) 2/66، والبديع في علم العربية (مجد الدين أبو السعادات المبارک بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالکريم الشيباني الجزري ابن الأثير ٦٠٦ هـ، تحقيق: فتحي أحمد علي الدين، جامعة أم القرى، مکة، ط1، ١٤٢٠هـ) 2/412.
([89]) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (محمد علي بن محمد بن علان ١٠٥٧هـ، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط4، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م) 8/557.
([92]) ينظر: سر الفصاحة (أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي ٤٦٦هـ، دار الکتب العلمية، بيروت، ط1 ١٤٠٢هـ _١٩٨٢م) 169.
([96]) شرح کتاب سيبويه (أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبدالله بن المرزبان ٣٦٨ هـ، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الکتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، ٢٠٠٨م) 1/121، وقال في موضع آخر: ((قالوا الغدايا والعشايا ولولا العشايا ما جاز الغدايا)) 5/247.
([97]) ليس في کلام العرب (أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه ٣٧٠هـ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط2، مکة المکرمة، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م) 71.
([98]) ينظر: ا التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والکوفيين (أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العکبري البغدادي محب الدين ٦١٦هـ، تحقيق: عبدالرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، ط1، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م) 258، شرح المفصل لابن يعيش 3/148.
([100]) ينظر: أعلام الحديث (أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ٣٨٨ هـ، تحقيق: محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، جامعة أم القرى، ط1، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م) 1/185.
([102]) ينظر: النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح (محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع - دار السلام للطباعة والنشر، ط1، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م) 123.
([105]) شرح السنة (محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ٥١٦هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، المکتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط2، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م) 5/416.
([106]) الميسر في شرح مصابيح السنة 1/71، وينظر تخطئة هذه الرواية أيضاً في: الکواکب الدراري في شرح صحيح البخاري 7/118، ومصابيح الجامع (بدر الدين محمد بن أبي بکر بن عمر بن أبي بکر بن محمد المخزومي القرشي، المعروف بالدماميني، ٨٢٧ هـ، تحقيق: نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط1، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م) 3/272، وشرح سنن أبي داود (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي ٨٤٤ هـ، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، ط1، ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م) 18/355.
([108]) ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إسحاق ابن قرقول ٥٦٩هـ، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر، ط1، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م) 2/20.
([111]) ينظر: کشف المشکل من حديث الصحيحين (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ٥٩٧هـ، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن – الرياض، ب ت) 3/243.
([112]) ينظر: کشف المشکل من حديث الصحيحين 3/243، والکواکب الدراري في شرح صحيح البخاري 7/118، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن الملقن المصري ٨٠٤هـ، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق – سوريا، ط1، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م) 10/37.
([114]) المفاتيح في شرح المصابيح (الحسين بن محمود بن الحسنُ الشِّيرازيُّ المشهورُ بالمُظْهِري ٧٢٧ هـ، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الکويتية، ط1، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م) 1/221.
([115]) شرح صحيح البخاري لابن بطال (أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملک بن بطال ٤٤٩هـ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مکتبة الرشد، الرياض، ط2، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م).
شَوَاهِد التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشکلات الجامع الصَّحيح (أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله، بن مالک الطائي الجياني٦٧٢هـ، تحقيق: طَه مُحسِن، مکتبة ابن تيمية، ط1، ١٤٠٥هـ) 3/321.
10. إِکمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم (أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، ٥٤٤هـ، تحقيق: يحْيَى إِسْمَاعِيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط1، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م).
11. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والکوفيين (أبو البرکات کمال الدين عبدالرحمن بن محمد الأنصاري الأنباري ٥٧٧هـ، المکتبة العصرية، ط1، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م)
12. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي، دار ابن الجوزي، ط1، ١٤٣٦هـ).
13. البديع في علم العربية (مجد الدين أبو السعادات المبارک بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالکريم الشيباني الجزري ابن الأثير ٦٠٦ هـ، تحقيق: فتحي أحمد علي الدين، جامعة أم القرى، مکة، ط1، ١٤٢٠هـ).
14. التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والکوفيين (أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العکبري البغدادي محب الدين ٦١٦هـ، تحقيق: عبدالرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، ط1، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م).
15. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (أبو العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المبارکفورى ١٣٥٣هـ، دار الکتب العلمية – بيروت، ب ت).
16. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 911هـ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، المکتبة العلمية، 1959م).
17. تصحيح الفصيح (أَبُو محمد، عبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُسْتَوَيْه ابن المرزبان ٣٤٧هـ، تحقيق: عبد الله جبوري، ط1، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1395هـ).
18. تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد (محمد بدر الدين بن أبي بکر بن عمر الدماميني ٨٢٧ هـ، تحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن محمد المفدى، بدون ناشر، ط1، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م).
19. تفسير البحر المحيط (أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، ط1، دار الکتب العلمية، بيروت، 1413هـ).
20. تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش ٧٧٨ هـ، تحقيق: علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام، القاهرة، ط1، ١٤٢٨ هـ).
21. التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ (عز الدين أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني ١١٨٢هـ، تحقيق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، مکتبة دار السلام، الرياض، ط1، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م).
22. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن الملقن المصري ٨٠٤هـ، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق – سوريا، ط1، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م).
23. التيسير بشرح الجامع الصغير (زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي ثم المناوي القاهري ١٠٣١هـ، مکتبة الإمام الشافعي – الرياض، ط3، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م).
24. الحديث والمحدثون (محمد محمد أبو زهو، دار الفکر العربي، ط2، القاهرة ١٣٧٨هـ).
25. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (عبدالقادر البغدادي، تحقيق: عبدالسلام هارون، مکتبة الخانجي ـ القاهرة، ط 1، 1406هـ ـ 1986م).
26. الخصائص (أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 392ه، تحقيق: محمد علي النجار، الطبعة الثانية، دار الهدى، بيروت، ب ت).
27. خصائص مسند الإمام أحمد (أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني ٥٨١هـ، مکتبة التوبة، ط1، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م).
28. دراسات في العربية وتاريخها (محمد الخضر حسين، المکتب الإسلامي، مکتبة دار الفتح سوريا، دمشق، 1380 هـ 1960 م).
29. الدرة الفاخرة (لحمزة ببن الحسن الأصبهاني، تحقيق : عبدالمجيد قطامش، دار المعارف - القاهرة، 1392هـ).
30. الدرة الفاخرة (لحمزة ببن الحسن الأصبهاني، تحقيق: عبدالمجيد قطامش، دار المعارف، القاهرة، 1392هـ).
31. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (محمد علي بن محمد بن علان ١٠٥٧هـ، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط4، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م).
32. ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، دار ومکتبة الهلال، 1418هـ).
33. سر الفصاحة (أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي ٤٦٦هـ، دار الکتب العلمية، بيروت، ط1 ١٤٠٢هـ _١٩٨٢م).
34. الشافية في علم التصريف (أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الکردي ٦٤٦هـ، تحقيق: حسن أحمد العثمان، المکتبة المکية – مکة، ط1، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م).
35. شرح التسهيل (جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالک 672هـ، تحقيق: عبدالرحمن السيد، محمد بدوي المختون، دار هجر ـ الرياض، ط1، 1410هـ ـ 1990م).
36. شرح السنة (محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ٥١٦هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، المکتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط2، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م).
37. شرح الفصيح (ابن هشام اللخميّ 577هـ، تحقيق: مهدي عبيد جاسم، ط1، 1409هـ).
38. شرح الکافية (محمد ابن إبراهيم بن جماعة 733هـ، تحقيق: محمد عبدالنبي عبدالمجيد، دار البيان ـ القاهرة، ط1، 1408هـ - 1987م).
39. شرح المفصل (أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا الزمخشري ٦٤٣هـ، قدم له: إميل بديع يعقوب، دار الکتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م).
40. شرح سنن أبي داود (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي ٨٤٤ هـ، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، ط1، ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م).
41. شرح صحيح البخاري لابن بطال (أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملک بن بطال ٤٤٩هـ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مکتبة الرشد، الرياض، ط2، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م).
42. شرح کتاب سيبويه (أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبدالله بن المرزبان ٣٦٨ هـ، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الکتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، ٢٠٠٨م).
43. شرح مصابيح السنة للإمام البغوي (محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّينِ عبداللطيف بنِ عبدالعزيز الرُّوميُّ الکَرمانيّ المشهور بـ ابن المَلَک ٨٥٤ هـ، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، إدارة الثقافة الإسلامية، ط1، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م).
44. شَوَاهِد التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشکلات الجامع الصَّحيح (أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله، بن مالک الطائي الجياني٦٧٢هـ، تحقيق: طَه مُحسِن، مکتبة ابن تيمية، ط1، ١٤٠٥هـ).
45. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثالثة، دار القلم للملايين، بيروت، 1404هـ).
46. صحيح مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ٢٦١ هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه، القاهرة، ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م).
47. طرح التثريب في شرح التقريب (أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بکر بن إبراهيم العراقي ٨٠٦هـ، أکمله ابنه: ولي الدين، ابن العراقي ٨٢٦هـ، دار إحياء التراث العربي، ب ت).
48. ظاهرة المشاکلة في الصرف العربي (ابراهيم جميل إبراهيم، مکتبة المتنبي، الدمام، ط1، 2005م).
49. عُقودُ الزَّبَرْجَدِ على مُسْند الإِمَام أَحْمد (عبدالرحمن بن أبي بکر، جلال الدين السيوطي ٩١١هـ، تحقيق: سَلمان القضَاة، دَار الجيل، بَيروت – لبنان، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م).
50. عمدة القاري شرح صحيح البخاري (أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى العينى ٨٥٥هـ، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ب ت).
51. فتح الباري شرح صحيح البخاري ( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 852هـ، رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه: محب الدين الخطيب دار المعرفة ، بيروت، ١٣٧٩هـ).
52. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (أحمد بن عبدالرحمن بن محمد البنا الساعاتي ١٣٧٨ هـ، دار إحياء التراث العربي، ط2، ب ت).
53. فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحکام (شيخ الإسلام أبو يحيى زکريا الأنصاري الشافعي الخزرجي ٩٢٥هـ، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبدالموجود، دار الکتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م).
54. الفصيح (أبوالعباس أحمد بن يحيى الشيباني المعروف بثعلب 291هـ، تحقيق: عاطف مدکور، دار المعارف، ب ت).
55. فيض نشر الانشراح من روض طيّ الاقتراح (جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بکر، السيوطي ٩١١هـ، تحقيق: محمود يوسف فجال، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث – الإمارات، 1423هـ – 2002م).
56. الکاشف عن حقائق السنن -شرح الطيبي على مشکاة المصابيح- (شرف الدين الحسين بن عبدالله الطيبي ٧٤٣ هـ، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، مکتبة نزار مصطفى الباز (مکة المکرمة – الرياض، ط1، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م).
57. الکتاب (عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه ١٨٠هـ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، مکتبة الخانجي، القاهرة، ط3، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م).
58. کشف المشکل من حديث الصحيحين (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ٥٩٧هـ، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن – الرياض، ب ت).
59. کفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه المعروفة بـ حاشية السندي على سنن ابن ماجه (نور الدين أبو الحسن محمد بن عبدالهادي التتوي السندي ١١٣٨هـ، دار الجيل - بيروت، ط2، ب ت).
60. الکناش في فني النحو والصرف (أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ٧٣٢ هـ، تحقيق: رياض بن حسن الخوام، المکتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، ٢٠٠٠ م).
61. الکواکب الدراري في شرح صحيح البخاري (محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الکرماني ٧٨٦هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، ط2، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م).
62. الکوکب الوهَّاج والرَّوض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (محمد الأمين بن عبدالله الأُرَمي العَلَوي الهَرَري، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور: هاشم محمد علي مهدي، دار المنهاج - دار طوق النجاة، ط1، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م).
63. لمعات التنقيح في شرح مشکاة المصابيح (عبدالحق الدِّهلوي 1052هـ، تحقيق: تقي الدين الندوي، دار النوادر - دمشق، ط1، 1435هـ - 2014م).
64. ليس في کلام العرب (أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه ٣٧٠هـ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط2، مکة المکرمة، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م).
65. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 392ه، تحقيق: علي النجدي ناصف، وعبد الحليم النجار، وعبد الفتاح شلبي، الطبعة الثانية، دار سزکين، 1406هـ).
66. مختصر في شواذ القرآن (أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه ٣٧٠هـ، مکتبة المتنبي، القاهرة، ب ت).
67. مرعاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح (أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبدالسلام بن خان محمد الرحماني المبارکفوري ١٤١٤هـ، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية، نارس الهند، ط3، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م).
68. مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح (نور الدين أبوالحسن علي بن محمد الملا الهروي القاري ١٠١٤هـ، دار الفکر، بيروت – لبنان، ط1، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م).
69. مسند الإمام أحمد بن حنبل (الإمام أحمد بن حنبل ٢٤١ هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبدالله بن عبدالمحسن الترکي، مؤسسة الرسالة، ط1، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م).
70. مصابيح الجامع (بدر الدين محمد بن أبي بکر بن عمر بن أبي بکر بن محمد المخزومي القرشي، المعروف بالدماميني، ٨٢٧ هـ، تحقيق: نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط1، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م).
71. المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد (شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري 833هـ، مکتبة التوبة، الرياض 1410هـ - 1990م).
72. مطالع الأنوار على صحاح الآثار (إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إسحاق ابن قرقول ٥٦٩هـ، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر، ط1، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م).
73. المفاتيح في شرح المصابيح (الحسين بن محمود بن الحسنُ الشِّيرازيُّ المشهورُ بالمُظْهِري ٧٢٧ هـ، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الکويتية، ط1، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م).
74. المفتاح في الصرف (أبو بکر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الفارسي الجرجاني ٤٧١هـ، تحقيق: علي توفيق الحَمَد، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م).
75. المفصل في صنعة الإعراب (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله ٥٣٨هـ، تحقيق: علي بو ملحم، مکتبة الهلال – بيروت، ط1، ١٩٩٣م).
76. المفهم لما أشکل من تلخيص کتاب مسلم (أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ٦٥٦هـ، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال، دار ابن کثير، دمشق – بيروت، دار الکلم الطيب، دمشق – بيروت، ط1، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م).
77. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الکافية (أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي ٧٩٠ هـ، تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين وآخرون، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مکة المکرمة، ط1، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م).
78. مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: (عثمان بن عبدالرحمن بن الصلاح 643هـ، نشره محمد راغب الطباخ، المطبعة العلمية، حلب، 1993م)
79. منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر (علي عبدالباسط مزيد، الهيئة المصرية العامة للکتاب، ب ت).
80. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (أبو زکريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ٦٧٦هـ، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط2، ١٣٩٢هـ).
81. الميسر في شرح مصابيح السنة (فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبدالله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي ٦٦١ هــ تحقيق: عبدالحميد هنداوي، مکتبة نزار مصطفى الباز، ط2، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م).
82. النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح (محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع - دار السلام للطباعة والنشر، ط1، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م).
83. النکت على کتاب ابن الصلاح (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ٨٥2هـ، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط1، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م).
84. النهاية في غريب الحديث والأثر (ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارک بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالکريم الشيباني الجزري ٦٠٦هـ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، المکتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م).
85. النهاية في غريب الحديث والأثر (مجد الدين أبو السعادات المبارک الشيباني الجزري ابن الأثير ٦٠٦هـ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، المکتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م).
86. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بکر السيوطي، تحقيق: عبدالعال سالم مکرم، دار البحوث العلمية، الکويت، 1395هـ - 1975م).